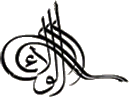خطبة الجمعة 22 رجب 1437: الشيخ علي حسن : الخطبة الأولى: وصية الإمام الكاظم للفضل بن يونس
عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن الكاظم(ع) أنه قال: (أكثِر من أن تقول: اللّهم لا تجعلني من المعارين ولا تُخرجني من التقصير). والفضل بن يونس هذا كوفي الأصل ثقة انتقل إلى بغداد وكان كاتباً في الدولة العباسية، وهو ما يشبه وظيفة أمين السر، وكانت وظيفة حساسة جداً. وقد روي عن محمد بن سالم، قال: (لما حُمل سيدي موسى بن جعفر(ع) إلى هارون، جاء إليه هشام بن إبراهيم العبّاسى، فقال له: يا سيّدى، قد كتب لي صكّ إلى الفضل بن يونس، فتسأله أن يروج أمري) أي يسرع في تنفيذه (قال: فركب إليه أبو الحسن (ع)، فدخل عليه حاجبُه، فقال: ياسيّدي، أبو الحسن (ع) بالباب. فقال: فإن كنتَ صادقاً فأنت حرّ ولك كذا وكذا، فخرج الفضل بن يونس حافياً يعدو حتى خرج إليه، فوقع على قدميه يقبّلهما، ثمّ سأله أن يدخل فدخل، فقال له: اقضِ حاجة هشام بن إبراهيم، فقضاها، ثمّ قال: ياسيّدي قد حضر الغداء فتُكرمني أن تتغدّى عندى؟ فقال: هات...). نعود إلى الوصية حيث استغرب الفضل المقطع الأخير من وصية الإمام(ع) له، ولذا بادر بالسؤال:
ـ (قال : قلت له : أمّا المعارون فقد عرفتُ أنّ الرّجل يُعار الدّين ثمّ يَخرج منه) فالبعض من النّاس لا يثبت الدّين في عقولهم وفي قلوبهم، بل إنّ الدّين يدخل في كيانهم كشيءٍ مستعار، لا يتجذر في وجودهم، بل يبقي حالة طارئة قابلة للزوال في أية لحظة نتيجة عوامل معينة من قبيل الغنى بعد الفقر، أو الفقر بعد الغنى،
والعجب، والرئاسة، والانغماس في الشهوات والمعاصي، وأمثال ذلك.
ـ وخير مثال على ذلك قوله تعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)[الأعراف:175-176].
ـ ولذا لا ينبغي لأحدنا أن يعتمد على ما هو عليه الآن، كما وتبرز أهمية المراقبة، والمحاسبة، واتخاذ خطوات الإصلاح تجاه مَواطن الخلل، ويُنصح أن يُكثر الإنسان من قول: (اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا
إلى خير، وتوفَنا وأنت راضٍ عنا).
ـ نعود للوصية، فقد تساءل الفضل بعد ذلك قائلاً: (فما معنى لا تُخرجني من التقصير؟ فقال: كلّ عمل تريد به وجه اللّه فكن فيه مقصّراً عند نفسك) فلا تشعر بأنّك أدَّيت إلى الله حقَّه، مهما عبدته، ومهما قدَّمت له من ألوان الطّاعة، بل عليك أن تَشعر بأنّه لا يمكن للإنسان أن يبلغ حقَّ الله في كلّ ما يعمل من عملٍ أو يطيع.
ـ (فانّ النّاس كلُّهم في أعمالهم فيما بينهم وبين اللّه مقصِّرون، إلاّ مَن عصَمه اللّه) ومع هذا نجد أن الّذين عصمهم الله يتحدَّثون في أدعيتهم بلغة التّقصير تواضعاً في ذلك، فكيف بمَن هم سواهم؟
ـ وفي حديثٍ آخر عنه(ع): (فإنَّ الله لا يُعبَد حقَّ عبادته). وهذا هو الواقع على مستوى مقارنة نِعَمِه بطاعاتنا وعلى مستوى إخلاصنا في تلك الطاعات، ومقدارها من حيث الكم والكيف، علاوة على أننا إنما نعمل الخير من خلال النعم التي ينعم بها علينا.
ـ إن الشعور والتذكير الدائم بالتقصير نحو الله سبحانه من ضروريات المحافظة على العلاقة مع الله بصورة نابضةٍ بالحياة، مفعمةٍ بالنشاط، لأنَّ النفسَ مِن طبعِها أن تَمَل، ولأن العُجُبَ مهلَكةُ الإنسان ومَحرَقةُ الأعمال، وما أجمل المناجاة السجادية حيث يقول(ع) مخاطباً المنعم سبحانه: (فآلاؤُك جَمّةٌ، ضَعُف لساني عن إحصائِها، ونَعماؤُك كثيرةٌ قَصُر فهمي عن إدراكها، فضلاً عن استقصائها. فكيف لي بتحصيل الشكر، وشُكري إيّاك يفتقرُ إلى شكر؟! فكلّما قلتُ: لكَ الحمد، وَجَب علَيّ لذلك أن أقول: لكَ الحمد).