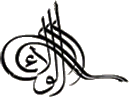خطبة الجمعة 8 رجب 1437: الشيخ علي حسن : الخطبة الثانية: الإمام علي (ع) والبراغماتية
ـ (البراغماتية) أو (المذهب العملي) أو (العملانية) من المصطلحات التي شاع استعمالها في عالم السياسة، وهو مذهب فلسفي سياسي ظهر في الولايات المتحدة أواخر القرن التاسع عشر.
ـ البراغماتية تَعتبر أن نجاح العمل هو المعيار الوحيد للحقيقة والقيمة.. وبالتالي فالصالح اليوم قد يصبح خطأً في الغد، إذ لا توجد قيم وحقائق ثابتة.. الاهتمام يجب أن يكون منصباً على النتيجة، ولا تهمنا المقدمات.
ـ قد تبدو هذه الفلسفة جميلة من ناحية، وقبيحة من ناحية أخرى.. هي جميلة على اعتبار أن الإنسان يطمح إلى النجاح في مشاريعه.. وقبيحة على اعتبار أنها لا تعترف بقيم وحقائق وثوابت ومبادئ.. لا تعترف بخير وشر.. المهم النتيجة.. وهي بهذا اللحاظ تقترب من الميكافيلية المتمثلة في كون الغاية تبرر الوسيلة.
ـ ولكن يبدو أن كثيراً ممن يستعملون هذا المصطلح لا يلاحظون هذا البعد القبيح في مضمونه، بل يركزون على مسألة المرونة في التعاطي مع المشكلة وتحقيق النتائج والنجاح المرتكز على ذلك، وسنجاريهم في ذلك.
ـ قال البعض ببراغماتية رسول الله (ص)، وفق المعنى الشائع للمصطلح، وبافتقاد الإمام علي (ع) لهذه الصفة واستشهدوا على ذلك بأمور ومواقف، من بينها ما جرى بعد غزوة حنين، حيث أعطى المؤلفة قلوبهم نصيباً إضافياً ـ وذلك من حصة الخمس ـ فمثلاً عندما نال أبوسفيان مائة بعير وأربعين أوقية فضة، قال للنبي(ص):
(حظ ابني يزيد!) فأعطاه أيضاً مائة من الإبل وأربعين أوقية، فقال: (فأين حظ ابني معاوية؟) فأمر له بمائة من الإبل وأربعين أوقية، حتى أخذ أبو سفيان يومئذ ثلاثمائة من الإبل ومائة وعشرين أوقية من الفضّة. فقال عند ذلك: (بأبي أنت وأمّي يا رسول اللّه، لأنتَ كريمٌ في الحرب والسِّلم. هذا غايةُ الكرمِ، جزاك اللّه خيراً).
ـ قالوا: هذه البراغماتية عند النبي (ص) هي التي جعلته ينجح في استمالة الناس من حوله، وبذا أمِن شرَّهم، ووطّد أركان دولته.. وفي المقابل، افتقد الإمام علي (ع) هذه الميزة، واستشهدوا بشواهد من بينها:
ـ الشاهد الأول: (أنه ولّى طلحة اليمن والزبير اليمامة والبحرين، فلما دفع إليهما عهديهما، قالا له: وصلَتْك رحم. قال: وإنما وصلتكما بولاية أمور المسلمين) أي لم ألحظ القرابة في تعييني لكما (واستردّ العهدين منهما، فعتبا من ذلك، وقالا: آثَرْتَ علينا. فقال: ولولا ما ظهر من حرصكما فقد كان لي فيكما رأي).
ـ الشاهد الثاني: قيل له: (اعطِ هذا المال، وفضِّل الأشراف ومَن تخافُ خلافَه وفراقَه، حتى إذا استتب لك ما تريد، عُدتَ إلى أحسنِ ما كنتَ عليه من العدل في الرعية والقِسَمِ بالسويَّة)، فرفض الاقتراح وردَّه رداً عنيفاً وقال: (أتأمروني أنْ أطلب النصرَ بالجور فيمن وُلّيت عليه من أهل الاسلام؟ والله لا أطُورُ به ما سمَر به سمير، وما أم نجمٌ في السماء نجماً) أي لا أقاربه أبداً (ولو كان مالُهم مالي لسوَّيْتُ بينهم، فكيف وإنما هي أموالُهم؟ ثم أزَم طويلاً ساكتاً) وكأنه أمسك غيظه ألا يكونوا قد أدركوا إلى الآن مبادئ الإسلام ومَن هو علي.
ـ والقول السابق قد يبدو قوياً من خلال المقارنة بين الشواهد، إلا أننا ن سجل عليه عدة ملاحظات:
1ـ نحن ننزه النبي(ص) كما ننزه الإمام(ع) عن البراغماتية بمفهومها الفلسفي الذي عرضناه، لأن المباديء والقيم والحقائق لم تكن نسبية عندهما، ولا تدور مدار النتائج، بل كانت ثابتة راسخة، وقد قال تعالى في شأن النبي (ص): (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) [القلم:9].
2ـ ما صدر عن النبي (ص) في زيادة المؤلفة قلوبهم ما كان تجاوزاً على مبدأ العدالة، بل كان استعمالاً لصلاحياته كحاكم ارتأى أن يستعمل خُمس الغنيمة ـ التي يعود أمر التصرف فيها إليه بحسب آية الخمس ـ في استمالة هؤلاء، دون أن يؤدّي ذلك إلى خلق حالة فساد إداري، أو تشجيع على فساد مالي.
3ـ امتناع الإمام عن تعيين طلحة والزبير كان متناغماً مع سنة النبي(ص)، وقد روى البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: (دخلتُ على النبي (ص) أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين: أمِّرنا يا رسول الله. وقال الآخر مثله، فقال: إنّا لا نولّي هذا مَن سأله، ولا مَن حرَص عليه).
4ـ لابد أن نقرأ تصرّف الإمام علي ضمن ظرفه التاريخي، فما كان ممكناً أن يستعمل الإمام بعض الموارد كخمس الغنائم مثلاً في استمالة المنحرفين عنه، إذ جاء الإمام إلى الحكم بعد أسبوع من ثورةٍ قامت على الفساد الإداري والمالي الذي ضجّ منه الناس وذاقوا منه الأمرّين، وأدى في النهاية إلى قتل الخليفة السابق.
ـ فكيف يمكن للإمام (ع) أن يتصرّف بالخمس مثلاً ويفضِّل البعض، أو يعيِّن بعضَ أقربائه كالزبير، لا من باب الاستحقاق بل بلحاظ القرابة، وبما يمكن أن يُفسَّر على أنه استمرار للفساد السابق؟
ـ لقد كان من المهم بالنسبة إلى الإمام علي(ع) في ذلك الظرف الحرج المليء بصور الانحراف عن مبادئ الإسلام في شؤون السياسة والحكم والإدارة والتقاضي وتوزيع الثروة، أن يركّز على المباديء والقيم والعناوين الأولية للأحكام، وأن يتجنّب أي تصرف يمكن أن يُفسَّر خلاف ذلك، لأنه حينها سيكون قد وجّه ضربة قاصمة لمشروعه القِيَمي التقويمي، وهو القائل: (ولقد أصبحنا في زمان قد اتَّخذ أكثرُ أهلِه الغدرَ كَيْساً، ونَسبَهم أهلُ الجهل فيه إلى حُسن الحيلة. ما لَهم قاتلهم الله؟ قد يرى الحُوَّلُ القُلَّب وجهَ الحيلة، ودونَها مانعٌ مِن أمر الله ونهيه، فيدعُها رأيَ عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتَها مَن لا حريجة له في الدين). لقد كان المطلوب من الإمام علي (ع) ـ من واقع مسؤوليته كإمامٍ وحاكمٍ على المسلمين ـ أن يعيد إلى تلك القيم والمباديء رونقَها وبريقَها، وأن يعيد ثقة الناس بحكم الإسلام، وأن يرسم معالم الطريق للحاكم المسلم الذي يريد أن يتعامل مع مثل هذا الظرف، وذلك حين ينخر الفساد في مفاصل الدولة، وتضج الجماهير من آثاره المدمّرة، فما قيمة أن يبقى الحاكمُ حاكماً فوق تلَّةٍ من فساد؟