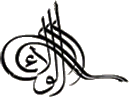توكل وقوة وعفو - الشيخ علي حسن
قال تعالى: (وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ) الشورى:36-43.
تجسيد القِيَم في علي:
عندما تتمعن في هذه الآيات تتجسد أمامك شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لاسيما عندما تسترجع تفاصيل سيرته خلال سنوات الحكم التي لم تكمل الخمس. فعناوين العبودية الخالصة لله والتوكل عليه والعفو عند المقدرة وإعمال الشورى والعطاء المادي والمعنوي والقوة في مواجهة البغي والتوازن في ردة الفعل تجاه المعتدي والركون إلى العفو والإصلاح عند توفر الأرضية لذلك.. كلها حاضرة في تلك السيرة، ونهج البلاغة في خطبه وكتبه وحكمه غني في هذا الإطار. وسأختار بعض ما سبق من عناوين من تجليات ذلك التجسيد.
التوكل على الله:
التوكل على الله يمثل اللجوء الكامل إلى الله والإيمان المطلق بقدرته وقوته، فما من شئ يغيب عنه، وما من شئ يحدث إلا بإذنه، ولو شاء أن يغيّر المقادير غيّرها: (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ) آل عمران:26-27، بمثل هذه العقيدة الواضحة ينطلق المؤمن في التوكل على الله، لأن النتيجة المفروضة هي الإيمان بأنه (وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) الطلاق:3. وقد روي عن رسول الله (ص) أنه قال: (من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن توكل على الله ذلّت له الصعاب وتسهّلت عليه الأسباب).
في نهج البلاغة أنّ أحدَ من كان في جيش الإمام علي عليه السلام عندما خرج لقتال الخوارج قال له: (يا أمير المؤمنين إن سرت في هذا الوقت خشيتُ أن لا تَظفر بمرادك من طريق علم النجوم). فقال عليه السلام بذلك الإيمان العميق والتوكل التام: (أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، وتخوّف من الساعة التي مَن سار فيها حاق به الضر؟ فمن صدق بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الإعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه، وتبتغي في قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه، لأنك بزعمك أنت هديتَه إلى الساعة التي نال فيها النفع وأمِن الضُّر؟) ثم أقبل عليه السلام على الناس فقال: (أيها الناس إياكم وتعلّم النجوم إلا ما يُهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى الكهانة والمنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. سيروا على اسم الله).
بين القوة والعفو:
وأما العنوان الآخر فهو أن في الآيات خطاب حول اللجوء إلى القوة في مواجهة العدوان، فالخلود إلى الضعف غير مقبول، والاستسلام أمام حركة البغي التي لا تتورع عن الظلم غير مبرَّرة، لأن الله لا يحب الظلم، ولأن السكوت عن الظلم قد يشجع الظالم والباغي على التمادي، إلا أنه عندما تكون الفرصة ماثلة أمامك كي تتنازل عن حقك أو أن تعالج الموضوع دون أن تلجأ إلى القوة، لا من موقع الضعف، بل من موقع القدرة على أخذه، انطلاقاً من روحية التسامح في شخصيتك، وترفّعاً عن الانتقام لنفسك، وتقرّباً إلى الله بذلك، فإن هذا التصرف يمثل قيمة عليا، تدل على قوة ضبط النفس، والصبر، والشهامة، ولذا أحبها الله وندب إليها ووعد عليها بالأجر العظيم.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مواجهة ذلك البغي يجب أن تكون بحدود البغي نفسه انتزاعاً لذلك من قوله تعالى: (وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا) فالعدل الذي يقوم على المعاملة بالمثل مطلوب حتى في مثل هذا الموقف، فلا يزيد حجم العقاب على حجم الجريمة، فذلك هو المقدار المسموح به.
وصايا الإمام في البصرة:
ولنتصور ذلك في حدود سيرة الإمام علي عليه السلام نعود إليه في لحظات حاسمة في حرب البصرة، قبيل بدء الحرب ليوجِّه تعليماته إلى جنده، لا بروحية الباحث عن الانتقام والتشفي، بل بروحية المضطر إلى القتال، الذي يلتزم برد الإساءة بمثلها لا أكثر، هذا إن لم يمكن التجاوز والعفو، فهو الأقرب إلى قلبه عليه السلام.. قال: (لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم حُجَّة أخرى، وإذا قاتلتموهم فلا تُجهزوا على جريح، وإذا هزمتموهم فلا تُتبعوا مدبراً ولا تكشفوا عورة ولا تمثّلوا بقتيل، وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً ولا تدخلوا داراً ولا تأخذوا من أموالهم شيئاً، ولا تهيِّجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم).
في صفين استبطأ أنصار الإمام الإذن في القتال وقالوا: يا أمير المؤمنين، خلّفنا ذرارينا ونساءنا بالكوفة، وجئنا إلى أطراف الشام لنتخذها وطناً ! ائذن لنا في القتال، فإن الناس قد قالوا. قال لهم عليه السلام: ما قالوا ؟ فقال منهم قائل: إن الناس يظنون أنك تكره الحرب كراهيةً للموت، وإن من الناس من يظن أنك في شك من قتال أهل الشام. فقال عليه السلام: ومتى كنت كارهاً للحرب قط ؟! إن من العجب حبّي لها غلاماً ويفعاً، وكراهيتي لها شيخاً بعد نفاد العمر وقرب الوقت ! وأما شكّي في القوم فلو شككت فيهم لشككت في أهل البصرة، والله لقد ضربتُ هذا الأمر ظهراً وبطناً، فما وجدت يسعني إلا القتال أو أن أعصي الله ورسوله، ولكني أستأني بالقوم، عسى أن يهتدوا أو تهتدي منهم طائفة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي يوم خيبر: لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس).
وبحسب نهج البلاغة أنه قال في مثل هذا الموقف: (أما قولكم أكل ذلك كراهية الموت فوالله ما أبالي أدخلت إلى الموت أو خرج الموت إلي. وأما قولكم شكاً في أهل الشام فوالله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها).
هكذا كان علي عليه السلام في إيمانه.. في توكله.. في قوته.. في بصيرته.. في قلبه الكبير.. وفي كريم خلُقه..