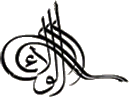الإسلاميّون وتوزّع الأدوار - جعفر فضل الله
تتميّز الحركة الإسلاميّة، وكذا المثقّف الإسلامي، بحضور قويّ للفكر الإٍسلامي النظري في الخطاب وفي توجيه السلوك على أرض الواقع؛ وذلك بسبب الزخم التنظيري المبثوث في القرآن الكريم والسنّة الشريفة، والذي يشكّل أرضيّة لثقافةٍ مشتركةٍ بين القاعدة الشعبيّة وقيادتها؛ نظراً لارتباط القاعدة الوجدانيّ والعقيديّ بالقرآن تحديداً، وبما صحَّ من السنّة. ولكنَّ هذا الزخم النظري ليس إلا عبارة عن اجتهادات المجتهدين، وفكر المفكّرين، الذي يتنوّع بتنوّع مشاربهم وثقافاتهم وما يؤثّر في حركة إنتاج الفكر عموماً، ومن الطبيعي إذ ذاك أن تختلف وجهات النظر، وأن يُصبح النقدُ الوسيلة الفُضلى في عمليّة تلاقح الأفكار، بالنحو الذي ينفتح فيه المجال الفكري التنظيري على مصراعيه في إطار الواقع الإسلاميّ، بما يُغني حركة الإنسان نحو الحقيقة، وبما يسرّع عمليّة التكامل في حركة التطوير للذات وللمجتمع.
ذلك؛ أنّ أيّ مجتمع، أو حالةٍ، أو فردٍ، يتّخذ قراراً بالانغلاق الفكري سيدخل في عمليّة اجترار داخلي للأفكار والمعتقدات، والتي تتحوّل عند لحظةٍ ما إلى تضخيم للذات المفكّرة، أو للفكرة المُنتَجة، بشكل لا واعٍ في ظلّ مواجهة متغيّرات الزمن، بهدف المحافظة على ذات الجماعة، وتتباطأ في تلك اللحظة حركة التطوّر، وتقلّ مساحة التفكير ما خلا الفكر التبريري لما هو قائمٌ من الأفكار والسياقات وما إلى ذلك.
نؤسّس هنا للقول إنّ الاختلافات الاجتهاديّة في عالم المثقّفين والحركيّين الإسلاميّين أمرٌ لا مفرَّ منه؛ بل ربّما يصل الاختلاف إلى حدّ التنافر في النظرة إلى الواقع، أو إلى آليّات التعاطي معه ضمن المنظومة الفكريّة.. هذا كلّه يجعلنا أمام عدّة خيارات:
الخيار الأوّل: أن نجعل من الاختلاف في الآراء أساساً للرفض والتعصّب والإلغاء.
الخيار الثاني: أن نحاول أن نجمّد أيّ حالة تداول للاختلافات فيما بيننا.. والمشكلة هنا أنّ السكون ظاهريّ، لا يمنع أيّ فردٍ أو جماعةٍ من أن تقضّ مضجعها الأسئلة الحائرة، التي يُمنع التداول في أجوبتها، بما يؤسّس لبنية ضعيفة غير متماسكة أمام المتغيّرات التي قد تأتي بأسئلة أكثر إلحاحاً، وتفترض صوغ الأجوبة في حالات أكثر هدوءاً، فتضيع بذلك القاعدة كلّها تحت ضغط ضربات الواقع. أمّا إذا لم نُجب على الأسئلة والإشكالات، فإنّ هذه الأسئلة تتحوّل إلى فجوات، حتّى إذا تراكمت فوق بعضها البعض، تحوّلت إلى خلل في بناء الإنسان. وهنا نجد أنّ هذه الفجوات تهيّئ الأرضيّة للغلوّ والتسليم بالأفكار التي لا بُرهان عليها، ممّا قد نُدرجه تحت مسمّى الخرافة.
هذا كلّه يدفعنا إلى تبنّي خيارٍ ثالث، وهو احتضان الحريّة الفكريّة، في إطار المحافظة على الإستراتيجية الإسلاميّة في هذا المجال. وما نرمي إليه هنا، هو أنّ كلّ فكرٍ ينشأ في قلب المجال الاجتماعي أو السياسي أو الفكري العام، وفي المجال الديني بطبيعة الحال، قد يمثّل شيئاً ممّا يسدّ الفراغ في مسيرة المجتمع في إنتاج الفكر وتطوير المعارف، حتّى الفكر النقدي الذي يواجه الفكر السائد هو جزءٌ من حركة إجابة على أسئلة حائرة قد تكون ثارت في ذهن المفكّر، أو في ذهن جماعة، وقد تثور لاحقاً في أذهان آخرين.
كلّ ذلك يفترض أن لا يتقبّل المجتمعُ اختلاف الآراء والنظرات والأفكار فحسب، وإنّما أن يرعى البنى والأجهزة والأسس التي تكفل حرّية الفكر والنقد.. هذا هو مسار تطوّر المجتمعات؛ وإنّ أيّ مجتمع لا يُمكن أن يُبنى على كبت الأفكار المختلفة مع الفكر السائد، أو التي تصطدم بالفكرة المشهورة أو المألوفة اجتماعيّاً، ما دامت تفترض أنّها تأخذ بالدليل والبُرهان، بحيث يكون هذا المعيار هو الأساس في قبول الأفكار ورفضها، وقد يكون دليلي على الفكرة قويّاً في نظري ولكنّه ضعيف في نظر آخرين، أو بالعكس؛ ممّا يفتح الباب أمام الانفتاح الفكري الذي يأخذ بأسباب الحوار أساساً لصراع الأفكار بما يهيّئ الساحة للفكر الأقوى دليلاً وبُرهاناً.
وهنا ينفتح الباب أمام ما نسمّيه ضبط الفكر بالفكر، بمعنى أنّ الفكر لا يُمكن أن ينضبط إلا من خلال قواعد إنتاج الفكر نفسه، فالفكر الأضعف دليلاً سيتلاشى أمام الفكر الأقوى، في الوقت الذي ينبغي أن نشعر فيه ـ كأفراد وكمجتمع ـ أنّنا معنيّون بالفكر الأقوى ثبوتاً وبنية، لا بالفكر الأضعف؛ لأنّ قوّة الفكر عندما تكون ذاتية، فهذا يعني أنّه يمتلك قوّة الحقّ في داخله، أي أنّ دليله قويّ وبُرهانه متين، وبالتالي يكون الفكر الأضعف ـ مقابله ـ هو فكر الباطل، والمؤمن مرتبط بالحقّ لا بالباطل بطبيعة الحال، قال تعالى: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) يونس: من الآية 32.. يتبع.